مرحباً بأصدقاء الأدب والكُتب, هنا ملتقى الأدباء ومجلة الكُتاب العظماء, هنا حيث ننثر من ربيع الكلمات مطراً .. أهلاً بكم
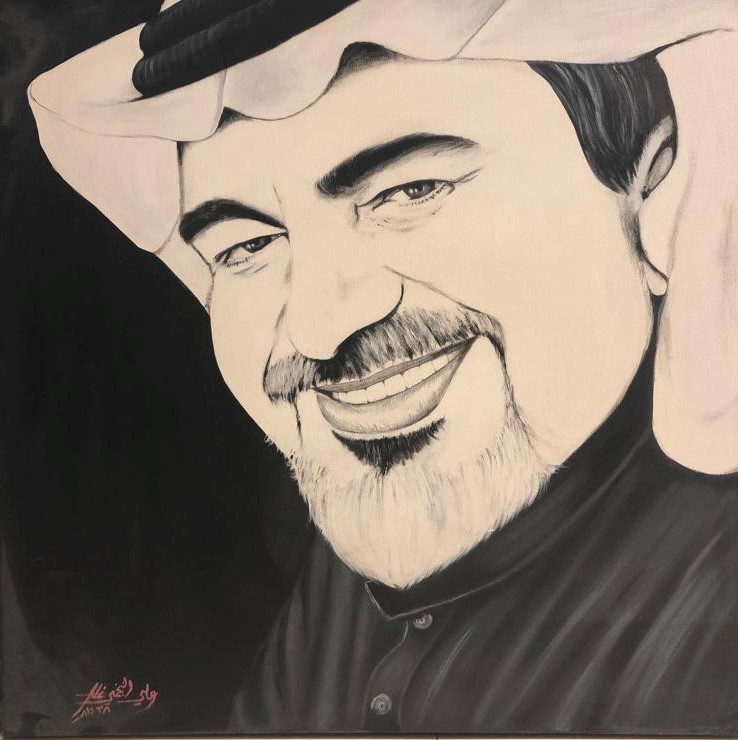
قراءة نقدية في نص الشاعر حسين صميلي
————————————
على هامش الأربعين ..!
تُراودُنا رغبةٌ في الضُّلوعِ
تُحدِّقُ من أفقِها الضَّيِّقِ
تُحوِّمُ صوبَ مَغانٍ تضوعُ
لتقطفَ من وردِها المُعبِقِ
ففي الوقتِ ما يستحقُّ الشروعَ
فما ضاعَ أكثرُ ممَّا بقي
فيصرخُ من عمقِنا ناصحٌ :
تشيَّخَ في الروحِ ممَّا لقي !
كبُرنا على لحظةٍ من هُيامٍ
تعلِّقنا في جوى مُطبِقِ
على مَوعدٍ للغرامِ تدانى
فيلهو بنا الظنُّ ..
هلْ نلتقي ؟
على كلِّ ما يستفزُّ الجمالَ
بأرواحِنا عَلَّها ترتقي
وعن دهشةٍ لم تعدْ طائراً
يرفرفُ في عمرِنا المُرهَقِ
كبُرنا ولا زالتِ الأمنياتُ
تتوقُ لأنسِ المدى المُشرِقِ
يُغلِّفنا وجَعٌ لا يَجفُّ
تجذَّرَ فينا إلى المَفرِقِ !
أحقَّاً كبُرنا ؟
وما عادَ شيءٌ
يوشوشُنا للهوى الشَّيِّقِ ؟!
تُطوِّقُنا عُقدةُ الأربعينَ
وتسحبُنا للشَّجا المُحرِقِ
تُحنِّطُنا في الصَّقيعِ اتِّقاءً
ونجهلُ أسبابَ ما نتَّقي !
وندري بأنَّا على رُغمِنا
كبُرنا على خوفِنا المُحدِقِ
وما زالَ في وسعِنا أن نُحبَّ
الحياةَ افتتانا ولم نُسرقِ
وما العيشُ يا سيَّدَ الأربعينَ
إذا أنتَ لم تصبُ أو تَعشقِ ؟!
وأجملُ ما في الحياةِ شعورٌ
بأنَّكَ والبدرَ في خندقِ !
حسين صميلي
كالحقيقة وككل شيء تألفه في الحياة وأنت تعبر أيامك في رحلتك العمرية المجهولة المصير جاء العنوان ( على هامش الأربعين ) مألوفا ووادعا وأنيقا وبسيطا خال من التكلّف فلا تشعر أنك أمام نص شعري بل أمام عنوان رواية أو كتاب من كتب الأدب والذكريات والسير لا يجعلك تتوقف عنده كثيرا لسرعة نفاذه إلى الذاكرة والوجدان وكلوحة مرور إجباريةالإتجاه يحيلك إلى نصٍّ بدا جدولا رقراقا شفافا نقيّا تتدفق فيه الألفاظ والمعاني تدفقا إبداعيا بلاغة وإبانة تتأكد من خلالها وحدة القصيدة من حيث الرؤية والصور والتراكيب والتصاعد الدرامي ومن حيث الغايات والمقاصد والرسالة مما جعل منها درة ماسيّة لا يمكن تجزئتها ومن أي جانب نظرت إليها تشعرك بالجودة والجمال والإتقان ..، .. نص يمنحك ذاك الشعور المفعم بالسكينة ويثير في خاطرك تلك الأسئلة التي لطالما كانت أسئلة بلا نهايات ولا إجابات شافية، أسئلة عطشى تتوالد ذاتيا في منطقة الحيرة وعلي أفق المجهول وخط انعدام اليقين .. ، وحين تبلغ نهاية الطريق مع النص لا تدري ما إذا كنت قد غصت في أعماقه ام غاص في أعماقك ولا تدري ما إذا كنت تقرؤه أم هو من يقرؤك إذْ يدفعك جاهدا لاكتشاف الذات ولكي تتحلى بالشجاعة لخوض صراعاتها وقلقها وهي تتربع على هامش الأربعين وما بعدها .. .. لقد أعجبني كلاما للكاتبة الأمريكية (إيدا لوشان ) تقول فيه ( في مرحلة الأربعين يعرف الإنسان عن نفسه وعما يريده في الحياة أكثر مما عرفه طوال حياته ، وفي أشد لحظات الإحساس بالحزن والهزيمة يدرك أن ما يمر به ليس الا مزيدا من الوعي ومزيدا من اكتشاف معنى أن تكون إنسانا وتلك هي روعة أزمة منتصف العمر .) وفي ذات السياق يرى علماء النفس أن أزمة منتصف العمر ترتبط بتقييم متناقض للإنجازات السابقة والإخفاقات والصراع من أجل أهداف شخصية جديدة ، وتتميز بالاستبطان وتقدير الذات والوعي بمرور الوقت والاعتبارات المتعلقة بضياع العمر أو ضياع الفرض ..
لقد اختصر (النص )صفحات من علم نفس النمو في نصف ورقة وكأي حقيقة مدهشة فرض (النص )نفسه تاركا الباب مفتوحا على مصراعيه للدخول في عالمه ودروبه حيث تتساوى هوامش الماضي وتتراءى للذهن صور تلك الفراغات البيضاء على حواف المخطوطات ، فراغات مذعنة مملوءة بالتعليقات والاستدراكات والإيضاحات والتفسيرات وأحيانا بلاشيء وبرسوم وشخاميط وأزاهير وعيون دامعة وقلوب دامية تخترقها السهام ، وحين ترنو إلى المستقبل والمجهول يبدو لك هامشه فراغا يحيط بالفراغ فلا تدري بماذا يمكن أن تملأ كلا الفراغين ، فالبعد المستقبلي لهامش الأربعين يجعل اللحظة الآنيّة كنقطة تأمل حذرة في منتصف الطريق يضعنا إزاءها الشاعر ويشركنا معه في حقائقها حين يقول :
تراودنا رغبة في الضلوع
تحدق من أفقها الضيّق
تحوم صوب مغان تضوع
لتقطف من وردها المعبق
فمن خلال اللفظ (تراودنا ) يتجاوز الشاعر عتبة الذات الشخصية إلى الذات العامّة ويفتح آفاق النص الداخلية على العالم الخارجي حيث تكون تلك الرغبات الدفينة والأمنيات المكبوتة وبواكير الحلم والعشق الموؤود في الصدور حقيقة إنسانية وحالة وجدانية يتشاركها الجميع ..كما أن انبعاثها المتجدد وتداعياتها الجدلية في الذات في مرحلة الأربعين حقيقة أخرى تشكل ما يوصف (بأزمة منتصف العمر ) والمشترك فيها هو عودة الصراع والتساؤلات وما إذا كان هناك فرصة فيما تبقى من العمر لإطلاق سراح تلك الرغبات الحبيسة ومنحها حرية الظهور في عالم الشهادة والواقع ..؟
ففي الوقت ما يستحق الشروع
فما ضاع أكثر مما بقي .
فالاستئفاف هنا يمنحها بداية جديدة وقد جاء متتاليا إمعانا في التأكيد وكنتيجة لقوة الجدل المحتدم في الذات بين الممكن وغير الممكن ويتجلى هذا الجدل حين يقول الشاعر :
فيصرخ من عمقنا ناصح
تشيخ في الروح مما لقي
حيث يطل علينا الماضي بخبراته وتجاربه وقيوده ومعتقداته يتخفى بين ثناياها شبح السجّان وسياط القمع وبلسان الحكمة والمنطق يتحدث :
كبرنا على لحظة من هيام
تعلقنا في جوي مطبق
( كبرنا )
على موعد للغرام تدانى
فيلهو بنا الظن هل نلتقي
( كبرنا)
على كل ما يستفز الجمال
بأرواحنا علها ترقي
وعن دهشة لم تعد طائرا
يرفرف في عمرها المرهق
تأكيدات متتالية في عرض جميل ورائع يكشف عن عدم الاستقرار في الذات الأربعينية ويدفع برغباتها نحو الخضوع والرضى بالقيود وبالموجود فيكون جوابها لا واعيا ومع غصة من حزن وألم ( نعم ) ..
كبرنا ولازالت الأمنيات
تتوق لأنس المدى المشرق
يغلفنا وجع لا يجف
تجذر فينا إلى المفرق .
هكذا قرر العقل السجان ومع ذلك لقد كان هذا الإقرار يخفي جدلية حدثت مبكرًا في الوجدان تمثلت في تلك التساؤلات المكبوتة فكل قرار قيل يتضمن صيغة استفهام تأتي تداعيًا ذِهْنِيًّا يكاد القارئ أن يراها بأم عينيه فحين يكون القرار ( كبرنا على لحظة من هيام ) فذلك ليس إلا من قبيل التفكير بصوت مسموع رَدًّا على تفكيرٍ صامت يتساءل :
( أكبرنا عن لحظة من هيام ، وعلي موعد للغرام ، وعلي كل ما يستفز الجمال …؟ )
أحقا كبرنا ؟ وما عاد شيء
يوشوشنا للهوى الشيّق .
وهكذا يتبدّى كيف تحمل الكلمات في باطنها النفي والإثبات والسؤال والجواب ليس على نحو متناقض وإلغائي بل في حال بديع من الانسجام والترابط ، وحين تمكن الشاعر من المواءمة بين العقل السجان والروح القلقة والوجدان الثائر وجه الجدل نحو أرضية مشتركة وجمعهم في تساؤل مشترك يمثل الحقيقة المتفق عليها حين يقول :
وندري بِأنا على رغمنا
كبرنا على خوفنا المحدق
وما زال في وسعنا أن نحب
الحياة افتتانًا ولم نسرق
وما العيش يا سيّد الأربعين
إذا أنت لم تَصْبُو أو تعشق.
بعد ذلك تتوحد عوالم الشاعر ( العقل والروح والوجدان والمادة ) فيفتح باب الأمل على مصراعيه على أجمل ما في الحياة.
وأجمل ما في الحياة شعورٌ
بأنك والبدر في خندق.
لم يكن الشاعر مبدعًا في العرض البلاغي شكلا ومضمونا فقط بل وكانت هواجسه الداخلية اللاواعية تتسم بالإبداع والتسامي والجودة مما تولد عنه هذا النص الرائع الجدير بالخلود .عبدالحميد عطيف

سؤال المواجهة ؛ولماحية الإجابة العميقة في نصِّ (من أنا؟!)؛للشاعرة/
هند النزارية
-عرْض النص:
من أنا؟!
مـن أنـا؟! يـا للشتات !
مـــا أقـــل الـمـفرداتْ!
حــــيـــرةٌ أوقــعــتَـنـي
فـيها فـخذ مـني وهاتْ
وأعــنِّــي إن تــكـرمـتَ
بــبــعـض الـمـعـطـيـاتْ
إنــــه لــغــزٌ وذهــنــي
مـنذ دهـر فـي سـباتْ
مـن أنـا؟! هل لي أنًا؟!
أم أنـني محض افتئاتْ!
أم تــرانـي حـلـقـة مــا
بــيــن مــفـقـود وآتْ؟!
ربــمــا نــقـطـة نــــون
فــي سـجل الـكائناتْ!
ربــمــا رمـــزٌ لـفـحـوى
الـتيه أو مـعنى الـفواتْ
ربـما اسمٌ جائزُ الصرف
عـــلــى رأي الــنــحـاةْ
فكرة في الغيب ضاعت
بــيـن رصـــدٍ وانــفـلاتْ
أأنـــبِّـــيـــكَ بــــســــرٍ
لـم يـزل في المبهماتْ
لـي هـنا ذاتٌ ولي في
الــعـالـم الـغـيـبي ذاتْ
ألــتــقــيـهـا كـــلـــمــا
ضـيعتُ مسبار الجهاتْ
ســوف أدعـوها مـساءً
لــنــحــلَّ الأحــجــيـاتْ
وسـأعـطـيـكَ جــوابـي
فـانـتظرْ حـتـى الـغـداةْ
____________________
-القراءة والتحليل:
هي ساعة ٌمن سويعات الزمن الراكض إلى مالانعلم من مجريات ومآلات؛تلوح كسحابة ريَّانة بالمطر في ثنايا نهار أوليل ،ساعةٌ لن تكون إلا استثنائية
في هباتها المصفَّاة من الشواغل وهيمنتها؛ومن المتاعب وأثقالها؛إلى أن
تتشكل نسيجاً ناعماً من اللحظات الهادئة التي يجنح إليها الكاتب أو الشاعر -وغيرهمامن المفكرين والفلاسفة وذوي النباهة-هنالك يحلو النأي بالنفس عن صخب الأجواء؛ والضجيج المستعر في محيط الحياة الإنسانية المنداحة؛وعن سفاسف الآراء؛والترَّهات؛والأقاويل ..
وساعتذاك تتاح مشروعية ملاقاة(الأنا) ؛ والإفضاء إليها؛ حرباً أو سلاماً.
وهي لحظات ستفرض على الشاعر أو الشاعرة أوغيرهما ذلك السؤال الجوهري المتسلل سرّاً وجهراً إلى دخيلته؛والمرتبط بطبيعته الخاصَّة ؛وكينونته التي هو عليها؛ورسالته في الحياة ؛وغايته التي يسعى إليها ويتوق إلى الظفر بها ؛وما إلى ذلك من رغبات ملحاحة مؤرِّقة؛فيتوجه حينذاك إلى ترجمة إجابته ؛في محاولة جادَّة باسلة تتيح له النفاذ الانسيابي إلى مكنونات ذاته ؛واستخراج أواستبطان هواجسها السلبية والإيجابية.
فإذا استطاع اصطياد شحناته وانفعالاته ؛لزمه إيداع تلك الخلجات النفسية الحبيسة في قالب فني مرئي من القوالب المحببة إلى نفسه:(مقالة؛قصيدة؛ خاطرة) الخ ؛
وفي أحيان أُخرى يحدث أن يأتي السؤال إليك مباغتاً من جهة قريبة أو بعيدة؛ضمن أسئلة حوارية معينة؛أوضمن طقس معين من الطقوس الاجتماعية؛تتطلب الحديث المباشر لا الكتابة،ولاتملك حينئذ إلا أن تجتهد في إيجاد إجابة دقيقة مكثفة؛آخذاً في الاعتبار أن تبلغ بعض درجات الإقناع إن استطعت الوصول إليها.
ولاجدال أنَّه أصعب سؤال مؤرِّق قد يواجَه به الإنسان أيَّاً كان في رحلة وجوده المترامية؛وتكمن الصعوبة في كون هذا السؤال؛أنه يتطلب التجرد التام من طغيان الأنانية ؛والتزام جانب الحياد؛وشفافية المكاشفة ؛وهي قيودٌ معنوية ذات سلطان نافذ لامجال لإنكاره؛ومن شأن ذلك أن ينحو بالكاتب منحى التفلسف الصارم؛فتجيء كتابته تبعاً لذلك مصطبغة بقدر غير يسير من التجريد والعقلانية.
والكاتب الملهم هو الذي يفطن إلى تلك المسافة الدقيقة بين الفكر وسلطته؛والوجدان واشتعالاته؛لئلا يفقد العمل الشعري رواءه وتأثيره المنشود؛في المتلقين على اختلاف طبقاتهم.
وفي هذا السياق يؤثر عن الفيلسوف أفلاطون قوله: «أصعب أنواع الصداقة؛ هي صداقة المرء لنفسه».
وهو إلى جانب ماذكرت سؤال زئبقي مباغت؛يفرض عليك التغلغل في بواطن النفس وسبرأغوارها بجلاء؛ حتى تقف على ذروة الضمير (أنا) باحثاً عما استقر في أكنافه من نوازع ومطالب ورغبات.
وفي كل الحالات لامفرَّ من المواجهة؛
ولو في إطار الكتابة الأدبية كما لدى شاعرة النص الذي نحن بصدده.
ولنا أن نتأمل -في مقام الاستئناس- حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الآتي؛ ملتمسين بعض مكنونات ضميره الإنساني؛ونفيه عن نفسه الزكية نزعة الفخر ؛كما قوله:
«أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر؛ وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولا فخر ؛وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخر ؛ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ ولا فخرَ».
فهو هنا يكشف لصحابته بعض المكارم الإلهية التي اختصه الله بها؛في ضوء الضمير(أنا) ؛اعترافاً منه بالفضل؛وإحاطة أصحابه بمنزلته العليا ؛بعيداً عن الادِّعاء أو المغالاة، أو ما شابه ذلك.
– [ ] وفي موضع آخر نراه -عليه الصلاة والسلام- يكشف لصحابته عن شجاعته في غَزوةِ حُنَينٍ؛متضرّعاً إلى الله أن يمنحهم النصر على الأعداء ؛كما في قوله:
أَنَا النبيُّ لا كَذِبْ
أَنَا ابنُ عبدِ المُطَّلِبْ!
فإذا اتجهنابالسؤال إلى شعراء التراث
كأبي الطيب؛وباغتناه بقولنا :من أنت يا من شغلت الناس ؛وملأت الكون شعراً ؟!
سنجد إجابات شتَّى ؛صاغها في العديد من قصائده في نبرات عالية؛ تبعاً للمواقف الدرامية التي اصطدم
بها ؛ كقوله الذائع:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.
وحينيذ سنستنبط أن نزعة الفخر المتضخمة؛هي الغالبة على تركيبته النفسية؛ وهي التي أملت عليه اعتداده الشديد بطموحات نفسه ؛والتنويه بعظمة مطالبها؛المتمحورة أو المستمدة من عزيمته الصادقة لبلوغ مراتب المجد العالية في عصره.
وقد تتخذ الأنا ثوباً آخر ؛كاستنطاق الكائنات الأخرى من خارج المنظومة الإنسانية ؛كما هو الحال عند حافظ إبراهيم ؛عندما ما تكلم باسم اللغة في عصره ؛مستشعراً مكانتها العظيمة؛وقدرتها على الصمود في وجه العاديات والأراجيف المحاكة ضدها وقتذاك ؛كما في في قوله:
أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ
فَهَل سَأَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي!
وعلى صعيد التصنيف؛نجد علماء اللغة يصنفون (لفظة أنا) ضميراً منفصلاً مستقلاً دالاً على المتكلم ؛في حين جعلوا لفظة (ياء) ضميراً متصلاً دالاً على المتكلم أيضاً؛إلى جانب ضمائر أخرى معروفة.
والضميران يصبان في نهر واحد من حيث الدلالة؛على مابينهما من فروق وتفصيلات لامجال للحديث عنها الآن..
وفيما يلي بعض الشواهد الشعرية عن ياء المتكلم في مقام حفاوة الشعراء بها؛وما أودعوه فيها من معانٍ نفسية.
قال الشاعر جميل بثينة:
وإني لأستبكي، إذا ذُكِر الهوى
إليكِ، وإني، من هواكِ، لأوجِل !
وعند أبي فراس الحمداني كما في قوله:
وَإنّي وَإيّاهُ لَعَيْنٌ وَأُخْتُهَا
وَإنّي وَإيّاهُ لَكَفٌّ وَمِعْصَمُ!
وعندبشار بن برد كما في قوله:
وإني أقاسي من جهادك خالياً
عياءً فأنَّى لي بأجر المجاهد؟!
وعند بهاء الدين زهير كما في قوله:
وإني ليدعوني الهوى فأجيبهُ
وإني ليثنيني التقى فأنيبُ !
وعند محيي الدين بن عربي كما في قوله:
فإني لكلِّ الاعتقاداتِ قابلٌ
وإني منكمْ مثلُ ما أنتمُ منا!
وعند محمد بن حازم الباهلي
كما في قوله الطريف:
فمنْ شاءَ تقويمي فإنِّي مقوَّمٌ
ومنْ شاءَ تعويجي فإنَّي معوَّجُ!
تلك كانت شواهد يسيرة من تراثنا العربي ؛جئت بها في مقام التعبير عن (الأنا) ؛توطئةً لالتماس مكنونات سؤال شاعرتنا في نصها الذي بين أيدينا.
******************************
تستهل الشاعرة نصَّها القصير المكثف بأداة الاستفهام (من) والمسؤول عنه (أنا)؛فكأنما هي بصدد تعريف الآخرين بشخصيتها الإنسانية وموقعها على خارطة الوجود..
وواضح أن طرفاً ذا صلة ما بالشاعرة تعمَّد مفاجأتها بذلك السؤال الشخصي؛وربما أُلقي عليها السؤال من جهة أدبية أو إعلامية تهتم بشعرها على نحو خاص؛
ورحلتها المتميزة في دنيا الحياة الأدبية
ضمن أسئلة أخرى طرحتْ عليها أثناء محاورتها؛على أنَّ محاولة الاستقصاء عن هوية السائل وصلته ليست بذي بال مقارنة بأجوبة الشاعرة؛وإحالاتها العقلانية الواردة في النص دون التنازل أو التضحية؛بأهمية الرواء الشعري اللازم في بناء التجارب الإبداعية ؛وهذا ما ستسلط القراءة الضوء عليه.
من نافلة القول أن السؤال جاء إليها مباشراً على هذه الصيغة(من أنتِ)؟!
ومن الطبَعي أنَّ مضامين لاعداد لها تنطوي تحت هذا السؤال الحادّ؛فهو -رغم قصركلماته-سؤال مفتوح على خبايا النفس الإنسانية؛ودهاليزها العميقة؛ونوعيتها؛وطبيعتها المتصلة بها؛واهتماماتها الواسعة؛وتعايشها مع واقعها المحيط بها؛ومافيه من أحداث مائجة ومواقف ؛وصولاً إلى استخلاص طابعها المستقلّ الداخل في نطاق رؤيتها الخاصة التي تتميز بها عن الآخرين؛من صُنَّاع الكلمة؛والوعي الذاتي المستقلّ.
– [ ] لم يكن أمام الشاعرة من مفرّوهي في هذا الموقف التأملي؛سوى الردّ الحاسم عليه المتأطر بالشاعرية؛ لا اللجوء مثلاً إلى فكرة التأجيل؛أوالجنوح إلى ماهيات خارجة عن نسيج السؤال ؛فما كان منها إذن إلا أن امتشقت بوصلتها الفنية؛وشحذت طاقتها الزاخرة؛واتجهت في ضوء تسلحها بالبيان والفصاحة إلى السباحة في بحر المكاشفة المركزة الساعية إلى تجلية أحاسيسها؛ونظرتها الوجودية؛وما إلى ذلك من رؤى أشعَّ بها النص.
ويبدو أنَّ الشاعرة استقبلت السؤال المفاجئ استقبال الحائر أي أفق يطرق؛أو أي نخلة باسقة يهزز جذعها؛ لا العاجز المنغلق على ذاته؛ولذلك ذهبت تصوّر معالم حيرتها بما يشبه
البحر المتلاطم الأمواج؛أوالبئر العميقة التي عمد السائل إلى إلقائها فيها.
وكون السؤال مباغتاًحسب اعتقادنا ؛ لايسوِّغ لنا هذا
أن نقول إنَّ الشاعرة كانت قبل ذلك خالية الذهن من سؤال مصيري كهذا ؛ سيلقى عليها؛في عاجل الوقت أو آجله؛
إذ لايتفق تصور ساذج كهذا مع منجزاتها الشعرية السابقة؛بل إن كلَّ قصيدة وجدانية أطلقت سراحها في الآفاق نمَّت إلى الحياة الأدبية ببعض الأوصاف عن طبيعتها؛وحملت إلى المتلقي إشارات معينة عن واقعها؛أوَ ليست القصيدة- في حد ذاتها-في تراكيبها اللغوية قطعاً تصويرية مستوحاة مما استقرّ بين الجوانح من رؤى وتطلعات؟!
لذلك مضت الشاعرة على صراط المواجهة طالبة إلى السائل مشاطرتها الحديث بإعمال الذهن معها؛وتزويدها ببعض المعطيات المساعدة لها على تجاوز هذا الامتحان العاصف الذي هي الآن في قاعته الصامتة؛وحيدة إلامما يمور به وجدانها ؛ومما تزخر به جوانحها ؛ومما تراه متسقاً مع حياتها ومحيطها المعاش..
بعد تلك اللمحات الذكية ؛قررت مجابهة سؤال الأنا على انفراد؛وأن تخوض ذلك البحر اللُّجي؛ومضى بها شراعها الجامح في هذا الفلك؛بين مدّ وجزر؛فالسؤال الواحد الذي أُلقي عليها؛تولَّدت عنه أسئلة أخرى كانت تصطرع في أعماقها؛وظلت تهطل عليها هطولاً لاهوادة فيه؛وحين لاح لها في خضم ذلك؛بصيصٌ من هدأة فكرية؛إن صح التعبير؛
وصفت السؤال العصي الملقى عليها في بداية الأمر أنه (لغز) على سبيل الإجمال؛وطبيعة اللغز الاستعصاء على الإجابة؛وألمحتْ إلى أن حضورها الذهني ساعتها؛واليقظة المطلوبة لمجابهة سؤال كهذا في سبات عميق.
لكنَّها مالبثت أنْ خرجت من دائرة ذلك الذهول الذي بسط نفوذه عليها ؛ وغلَّف منطقها بعض الوقت؛فمضت مسترشدة ببعض تصوراتها تترجم (أناها)؛على أنَّ الحيرة المستبدةماتزال قابضة على مساحات تفكيرها؛ومن هناك انهمرت عليها وطأة التساؤلات الذاتية الحادة؛فوقفت أمامها-والفزع يرسم دوائره حولها- تطالب ذاتها الأخرى المغيَّبة عن الإفصاح لها؛وتعيين طبيعتها على وجه التحديد؛فإذا بنا أمام ذاتين اثنتين انشطرتا ؛الأولى تسأل بإلحاح كالمستنجدة؛والأخرى مطرقة ذاهلة ..
وذلك بقولها:
أأملك حقاً (أناي) وتلك إشارة منها إلا أن الروح من علم الله ؛أم أن مايدور في ذهني من خيالات محض افتئاتْ؛مجرد اسْتِبْدَاد بالرأي؛أو مفتريات؛ترسخت في الذاكرة من عهود مبكرة؛
أم تراني مجرد حلْقة بين ماض أصبح مهملاً منسياً ؛وبين مستقبل غامض؛لاسبيل إلى اكتشاف معالمه.
وهي بذلك تتساوق مع ابن الرومي في قوله:
أخافُ على نفسي وأرجو مَفازَها
وأستارُ غَيْب اللّهِ دونَ العواقبِ!
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي
ومن أين والغاياتُ بعد المذاهبِ؟!
لقد بدت تلك الأسئلة الشائكة التي واجهت بها ذاتها؛محاصرة لها من كل الجهات؛ولاسبيل سوى المواجهة؛
فمضى بها تيارها العقلاني على شاطئ
(ربــمــا)ومن هناك أرادت تقريب صورة أناها على نحو فلسفي تجريدي؛فوصفت نفسها بنقطة نون؛تعبيراً منها عن تواضعها ؛وأعقبت ذلك بتسميتها (رمـــزٌ لـفـحـوى
الـتيه؛ أو مـعنى الـفواتْ)؛وفي ذلك إشارة منها إلى عُتمة زمن قديم؛ تشكلت فيه؛وإلى ما يتمخض عن (الفوات) من مطالب وآمال كانت تطمح إليها ؛إلا أنَّ الأبواب أُوصدت دونها.
وأملت عليها طرافتها الشعرية المشوبة بقدر من السخرية على نحو من الأنحاء نتيجة ما آلت إليه حياتها الماضية؛ أن تساير النُّحاة مومئة بذلك إلى اسمها المعروف بين الناس(هند) باعتبار جواز صرفه ومنعه طبقاً للقاعدة المعروفة.
ثم رأت أنَّها مجرد فكرة كانت في علم الغيب؛ وعندما همَّت بالتشكل على أرض الواقع ؛ضاعت معالمها بين (رصـــدٍ وانــفـلاتْ)؛وهما حالتان تنبئ عن عدم استقرار الروح ؛وعدم انسجامها مع جو متوتر كهذا..
ولما أحسَّت الشاعرة باستغراق السائل وذهوله وعدم الخروج بشيء مما أفصحت عنه في الإبانات الماضية؛ دنت إليه قائلة:هناك سرغامض ودفين في حناياي؛لم أعلن عنه لأحد من قبل؛وسأخصك به؛وهو ما يمكن تسميته (بالانشطار) أو الانفصال ؛حيث إنَّ لي ذاتين ؛شخصيتين واحدة تراها الآن رأي العين؛ذات كينونة محسوسة ؛ولها كيانها في عالم الحياة؛ومتطلباتها الحِسيَّة؛وأخرى متسربلة بعالم الغيب ؛محجوبة عن أنظار الناس أجمعين؛وهي التي أجنح إليها كلما خشيت العثار؛أو استغلقت عليَّ معالم الدروب؛ووجدتني في مهبِّ الضياع؛لا ألوي على شيء.
هذه الروح أجد عندها الأمن والسكينة؛وأجد عنها الرَّحابة وانفساح الأفق؛وهي وحدها تملك مفاتيح الإجابة الدقيقة عن سؤال الأنا؛وعن سائر الأُحجيات العالقة بذهنك.
ومن أجل ذلك سأدعوها؛وغداً ترقب الإجابة النهائية لذلك السؤال العصي.
تلك كانت جولة خاطفة في بعض معالم النص ؛على أمل أن تتاح فرصة أخرى لاستنتاج بعض سماته الفنية.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله.
___________________

قراءة نقديّة في مجموعة:”على أثير الجليد” للشاعر:عبدالستار نور علي
تشكل الغربة المكانيّة ممثلةً بالاغتراب عن الوطن ظاهرة إنسانيّة عامة لا ينفرد بها جيل دون جيلٍ آخر فهي موجودة منذ وطئ الإنسان هذه الأرض وبدأ طريق المعاناة.
ويبدأ الإحساس بالغربة عند الإنسان منذ لحظات الولادة الأولى ومغادرته رَحِمَ أمه الذي مكث فيه لأربعين أسبوعاً قبل أن يُقطع الحبل السِّري ويدخل الهواء لأوّل مرة في رئتيه مشكلا له صدمةً وإحساساً غريباً، دافعاً إياه لإطلاق الصرخة الأوّلى.
وعلى مدى سني عمره يتكرر هذا الإحساس ولكن بشكل آخر وبدرجات متفاوتة عند الإنسان، فيعبر عنه بصراخ ٍ من نوع آخر، وقد ينعكس على سلوكه وردّات فعله وطرق التعبير عنها.
غير أنَّ تجلّيات هذا الشعور عند الشعراء يأخذ منحىً إبداعياً بعد أن يفقد الغبطة الحقيقية بعيداً عن وطنه وقد”قيل لأحد الأعراب ما الغبطة ؟: قال: الكفاية مع لزوم الأوطان والجلوس مع الأخوان، قِيل له: فما الذلّة؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان.
وقد لازم الإحساس بالغربة الشعراء منذ القصائد الأولى التي خطتها يدُ الإنسان معبراً عن حنينه لأرضه ولأحبائه وللغبطة المُفتقدة، وامتدَّ ليتجسد بالأساطير الرافدينيّة، وليس أدلّ على ذلك من غربة كلكامش بعد أن فقد صديقه أنكيدو، لتستمر هذه الظاهره في الأدب الجاهلي والتي تمثلت بالبكاء على الأطلال، وما برز بعد ذلك في العصور الأمويّة والعباسيّة وصولاً إلى الأدب في العصر الحديث، ليظهر مفهوم (المكانيّة) في الأدب العالمي والتي وصفها غاستون باشلار” …بأنَّها الصورة الفنية التي تذكرنا بذكريات ماضية”.
ولأنَّها ماضية ومهشمة فإن الشاعر يلوذ بالحلم ليحقق توازناً عبر كتابة القصيدة، فالشعر على حدِّ وصف باشلار:”حلم مكتوب”
وفي مجموعة (على أثير الجليد) للشاعر العراقي المغترب (عبد الستار نورعليّ) تتجلى معاني الغربة بأوضح صورها عبر نصوصه التي تراوحت بين القصيرة والطويلة والمتوسطة.
* سيميائيّة الغلاف وتجلّيات العتبات النصيّة:
منذ النظرة الأولى يمنحك الغلاف شعوراً بالغربة، وبمدى الألم الذي تكتنزه الرموز والإشارات المرئية فيه حينما يتسع الجليد، ويتشكل ككائن الفقمة الذي يرفع رأسه إلى السماء وقد تجمّد جسده المكتنز، ومن زاوية أخرى يبدو كقاربٍ غرقَ في الجليد لترتفع مقدمته إلى الأعلى على خلفية تتساوى في فضاءاتها الزرقاء الأرض بالسماء لولا فاصلٍ من خط ضوءٍ شحيح هو كل ما تبقى من مساحة الأمل بعد أن تجلّل العنوان واسم الشاعر باللون الأسود تعبيراً عن حزنه لما فقده، وما فقده كان كبيراً، عالمه، أرضه، ووطنه، فسعى إلى لملمة حلمه المكتوب، وليكون”العنوان خلاصة دلالية لما يظنّ الشاعر أنَّه فحوى قصيدته أو الهاجس الذي تحوم حوله، فهو إذاً يمثّل تفسيرالشاعر لنصه”،وهو من العتبات النصيّة الأوّلى التي تحدد معالم المجموعة ومرجعياتها الإبداعيّة.
وقد عرّف علماء الألسنية العناوين:”بأنها مجموع الدلائل اللسانيّة من كلمات وجمل وحتى من نصوص تظهر على رأس النصّ لتدلَّ عليه، وتهيئهُ وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف وهذا ما يؤكده نصّ الشاعر الوارد في مقدمة المجموعة تحت كلمة (استهلال) والذي جاء فيه:
“حين تضيق السبل، يشعّ من الداخل ضياء يطفو لينير…حلم أنْ ترى الحروف سبيل النهار. الحروف التي عبرت مضائق المعاناة، واجتازت صخور الألم المدببة الملساء، تدمى أقدامها، تنزلق، ثم تنتصب، لتنطلق همسةً، صرخةً، من أعماق سيزيف، لا أنْ تنام في الظلِّ ملقاةً، يسامرها الغبار….
وجاء الإهداء ليضيف عتبة أخرى تؤكد لنا الإحساس ببرد الفقد وضياع الغبطة (والكفاية في لزوم الأوطان) كما قالها الجاحظ، ليلوذ شاعرنا بوطن ٍ ابتكره لنفسه وضاق به عليه هو وأسرته والتي أسماها وطنه والحضن الأثير وشعبه الأعزّ ليصنع غبطة ً وليذيب بعض الجليد كي تتسعَ مساحات النور.
وتأتي قصيدة المجموعة (أغنيات تُبثُّ على أثير الجليد) التي اجتزأ منها الشاعر العنونة والمؤلفة من عدد من المقاطع بعناوين فرعية لتؤكد تجلّيات غربته بكلِّ وضوح وتمنحنا إحساساً باللاجدوى والألم ومقدار الإحباط الذي عاشه الشاعر كما في نصّ (المغني):
“صعد المغني مسرحَ الكلامِ، غنّى… ثمَّ غنّى طربَ الناسُ ، انتشوا ، فبكى… وتوارت كلماتُه …
فما بين فرح الناس وطربهم ونشوتهم، يأتي بكاء المغني وهذا الشعور كافٍ أن يزرع الغربة في الروح في وقت لا يستطيع أن يبوح بما في قلبه وروحه.
ويأتي نصّ (الغريب) ضمن مجموعة النصوص المندرجة تحت عنوان (أغنيات تُبثُّ على أثير الجليد) لتمثل تصريحاً واضحاً على ما ذهبنا إليه:
“وكلُّ شيءٍ يُشعل الضجرْ نحملُ فوق القلبِ والرقابْ حقائبَ السفرْ فكلَّ يومٍ نختفي عن أرضْ ونلتقي بأرضْ ترفضنا الخطوط بين الطولِ… بين العرضْ …
وكذلك نصّ (القفز) يظهر لنا أثر الاغتراب والبعد عن الوطن في تفاقم الشعور بالقلق والألم وعدم الاستقرار،وهذا ما يزيد إحساس الشاعر بالغربة، وهو الساعي إلى الاستقرار والركون إلى أرضٍ تحتويه.
“قفزتَ بين الأرض والأرضِ… والأرضِ.. وسُحْتَ فتخطيتَ المكانْ قلْ لي متى تشعرُ بالأرضِ وبالأمانْ؟!
لقد عبّر شاعرنا هنا عن أحاسيسه والتي وصلت إلى ذروة التأجج حينما يتوجه بالسؤال لنفسه قائلا:”قلْ لي متى تشعرُ بالأرضِ وبالأمانْ؟!”
فهو بين الفعل الظاهر وهو القفز بين الأرض والأرض ،وبين الكثير من الألم الذي لم يعد ظاهراً، بل كشف عنه السؤال المرير لنفسه، يحقق تواجد”خصائص العناصر التي تجعل من الشعر شعراً… العناصر الظاهرة والخفية…
وجاء مقطع (الأمان) بما يشبه مقطع (القفز) من حيث المعنى والأفكار ولتأكيد المعاناة في رحلة الشاعر للبحث عن الأمان:
” لا شيءَ يستاهلُ أنْ تحملَهُ إلا الأمانْ فكلُّ ما مرّ على الإنسانْ في كلِّ عصرٍ وأوانْ البحثُ عن مكانْ ينعم فيهِ بثياب الحبِّ والأمانْ!
* تجلّيات صخرة سيزيف:
في قصيدته (الأحجار) يستدعي الشاعرهنا ثلاثة رموز الأول أسطوري إغريقي وتجسّد ب(سيزيف) ورمزين تأريخيين عربيين هما (عمار بن ياسر) وأمه (سميّة) من مشاهير الصحابيات في الإسلام، ليعبّر من خلاله الشاعر عن ألمه وسخطه على هيمنة القوة والسلطة، وما ينجم عن ذلك من ظلم ٍ ، فسيزيف يرفع الصخرة من أسفل الجبل إلى أعلى قمته وتسقط ليعود فيرفعها دلالة على ديمومة المعاناة والألم والعذاب الأبديّ، أما عمار وأمه سميّه فقد وُضعت الحجارة الكبيرة على صدريهما وهما مشدودان إلى رمال الصحراء الساخنة وتحت أشعة الشمس المحرقة ليوجه أبو جهل طعنة مميتة إلى قلب سميّة فماتت تحت أنظار ابنها لتكون أوّل شهيدة في الاسلام… وكلاهما تعرض لغضب الأرباب، فسيزيف حصل له ماحصل بسبب غضب الآلهه لتمرده عليها، وكذلك للرمزين العربيين بتمردهما على دين أسيادهما وإيمانهما بالإسلام وبقيمه السمحاء وهذا ما أختزله الشاعر في هذا النص ّ:
“يحمل فوق الكاهل حجراً يتسلق جبل الآلامْ يصعدُ… يهبطُ… في دائرةٍ، والأفقُ ظلامْ، عمارٌ يحبسُ صرختهُ سيزيفُ دؤوبٌ، مصروعٌ كالدولابْ ………. …… وسُميّةُ فوق الصدرِ الضامرِ حجرٌ ما أثقلُهُ !
وقد اختصر الشاعر النصّ بكلمتين وصف فيهما غربته وهما (الأفق ظلام) تعبيراً عن اليأس واللاجدوى وهما شكل من أشكال الغربة والابتعاد عن الحلم، الذي طالما سعى إليه وهو يبحث عن حياة آمنة مستقرة.
إن الشاعر بهذا الاستخدام الرمزيّ لم يسعَ إلى التوثيق وكتابة هذه القصة تأريخيا، بل سعى إلى تمرير رؤاه الفلسفيّة في رفضه لغربة روحه حينما يكون مستلباً ومسحوقاً بقوى عليا مهيمنة وبكل ما يمس كينونة الإنسان وسعيه إلى تحقيق أحلامه وخلوده حتى لوتطلب منه ذلك، وقوفه بوجه الآلهة.
وبهذا الصدد يقول الفيلسوف أرسطو وهو يتحدث عن قيمة الشعر:”بأنَّه أقرب إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ” …..”وإنَّ الشاعر في محاكاته للأشياء يسبح في الكليات بدلاً من الجزئيات التي ألفَ التاريخ قولها”.
ولوعدنا إلى قصيدة (الغريب) لوجدنا ثمة تماثل وتطابق بين الشاعر و (سيزيف) في المعاناة حينما تتحول حقيبة السفر إلى صخرة سيزيف التي تثقل كاهله، وهو يحملها من بلد إلى بلد.
“وكلُّ شيءٍ يُشعل الضجرْ نحملُ فوق القلبِ والرقابْ حقائبَ السفرْ …
فهو ذات المشهد السيزيفيّ الذي يعيش معاناته الأبديّة شاعرنا، ولكن في رحلة البحث عن الأرض والأمان لتترك (الحقائب – الصخرة) أثرها ليس فوق الكاهل فحسب بل في القلب، لأنَّ التعب ليس جسديا ً فحسب ،وإنما هو تعب روحي وفكري وعاطفي يتجسد في غربة الروح الباحثة عن غبطتها المفقودة عبر الترحال.
وفي قصيدته (قال الحكيم بيدبا) يلبس الشاعر قميص سيزيف، ولكنَّه جاء به هنا عبر تناصّ آخر ألا وهو مقولة الإمام عليّ (كرّم الله وجهه) المعروفة«ذقت الطيبات كلّها فلم أجد أطيب من العافية، وذقت المرارات كلّها فلم أجد أمَرّ من الحاجة إلى الناس ،ولقد حملت الصخر والحديد فلم أجد أثقل من الدَين .»
وهكذا ينحو الشاعر هذا المنحى في وصف مكابداته فيقول:
“إني حملتُ الصخرَ والفولاذَ والقِمَمْ والحرفَ والأنوارَ والكلِمْ فلم أجدْ أثقلَ منْ كلام دجالٍ حَكَمْ ….
إنَّ مجرد إحساس الإنسان بأنَّ رقبته بيد الحاكم الذي يفعل به ما يشاء وكأنَّه مَدين له ،تمنحهُ شعوراً صادماً من الألم والغربة والخوف مِن أنْ يقطع سيف الحاكم رقبته لا لشيء إلا لأنَّه رفض منطقَهُ.
وتطلّ فكرة الصخرة السيزيفيّة برأسها مرة أخرى وبقوة في مقطع من قصيدة (شهادة):
“قد حملتُ الصخرَ والفولاذَ في الوادي السحيقِ، بين لوع الشجر الملتفِّ والأغصانِ والزهر الحريقِ، صاعداً نحو المسلّاتِ..
تعكس هذه التكرارات المرجعيّة الثقافيّة لشاعرنا (عبد الستار نورعليّ) واهتمامه بالموروث البلاغيّ الإسلاميّ والذي تحول في لاوعيه إلى مهيمنات فكريّة تتجسد صوراً في شعره يعيد تشكيلها للتعبير عن غربته وألمه ومعاناته وحريقه الذي هوحريق البلاد (العراق) عراق الحضارات ومسلّات العلم والمعرفة البشريّة الأوّلى، وهنا يتوحد عنده الخاص بالعام والذاتيّ بالموضوعيّ في عزفٍ سمفونيّ حزين يكون شاهداً على الخراب الذي حلَّ بالوطن.
وفي نص ّ (الرحيل) لجأ الشاعر إلى التضمين من التراث الشعبيّ تعبيراً عن حزنه من فقدان الأرض والأهل عبر دوامة التنقل في محطات غريبة لم تطأها قدمه سابقاً ولا تمثل له طموحه ولا تمت لذكرياته ولروحه بشيء مما جعله أمام غربة لا متناهية حينما يقول:
“يا فشلة الملهوف ويدور هله بمحطات” صرنا محطاتٍ حقائبَ ….!
* السندباد ومفارقة حلم العودة:
يعدُّ السندباد شخصية أسطوريّة من شخصيات ألف ليلة وليلة وهو بحّار من بغداد،عاش في فترة الخلافة العباسيّة، ويقال إن السندباد الحقيقي تاجر بغدادي مقيم في عُمان،
زار السندباد الكثير من الأماكن السحريّة وواجه الكثير من الصعوبات أثناء إبحاره في سواحل أفريقيا الشرقيّة وجنوب آسيا في رحلاته السبع، ومن هنا يأتي استحضار السندباد من قبل الشاعر لعقد مقارنة بينه وبين الصعوبات التي مرَّ بها الشاعر والسندباد على حدٍ سواء، وإظهار فقد الشاعر لحلم العودة إلى الوطن، والاندثار في غربته القاتلة منطلقاً من تقابل الفكرة، وتشظي الرمز، وإعادة تشكيله في ضوء ما يعكسه من معانٍ ودلالات:
“تحملُ الزادَ وتنأى عن سواقيكَ…. فترحلْ، ترسمُ الشوقَ على الريحِ… على الماءِ… على النخلِ… على الضلعِ… وتشهقْ (……..) سندبادٌ أنتَ؟ لا… فالسندبادْ حلمهُ طيفُ المعادْ،”
فقد رسم شاعرنا النصّ بثنائية واضحة حينما قرن نفسة بالسندباد، سوى بالحلم، فالسندباد متاح له تحقيق حلم العودة إلى وطنه وقد فعل لينعم بالدفءِ على عكس الشاعر الذي تعذرت عودته، وبهذا فقد فكَّ اقترانه بالسندباد، ليعود إلى غربته التي ألفها.
ويُظهرلنا الشاعر عبر هذا النصّ كيف فُرضت عليه الغربة والتي لم تكن حلمه، وخارج سقف توقعاته، ولذا فهو يتوجه لنفسه بالسؤال فيقول:
“سندبادٌ أنتَ؟! هذي رحلةٌ ليستْ على خارطةِ الحُلْمِ على ما كانَ ينوي السندبادْ، سندبادٌ أنتَ منْ أشتاتِ أرضٍ …”
ويتأكد هذا المضمون ـ أي الهجرة القسريّة والترحال ـ في قصيدة (رشدي العامل) والتي يصرح فيها عن رفضه للهجرة والترحال:
“في كلِّ يومٍ هجرةٌ، فشاعرٌ يحطُّ بينَ غابةٍ تلتفّ بالأشباح والأضدادْ” ………… ”وشاعرٌ ماتَ مع المساءْ، في كلِّ يوم هجرةٌ… منفىً… رؤىً..صمتاً… واختفاء،”
تُظهر لنا هذه القصيدة بكلِّ جلاء اندفاع الشاعر إلى غربته ورحلاته السندباديّة قسراً بفعل الأشباح والأضداد الذين يحاصرون الشعر والشعراء في غابة اسمها الوطن.
ولذا فللشاعر كلّ يوم منفى واحتمال موتٍ وهذا ما حصل للشاعر العراقي رشدي العامل.
ويأتي استدعاء هذا الرمز الثقافي في المجموعة إلى جانب رمز ثقافي آخر هو المبدع (بلند الحيدري) الذي وصفه بأنّه شيّد جسراً بين وجهين وأقام صرحاً لرسوخ الحبّ ليطلَّ بعدها من خلال رمزفكري ثالث وهو (الحلاج) على موضوعة الثبات على قول الحقّ والمبدأ، حتى لوكلف ذلك الإنسان أن يهرب إلى منفاه، أو حياته بالصلب والذي اختاره الحلاج مزهواً:
“هو ذا الحلاجُ مصلوباً ، ويزهو دون أنْ يعرفَ للخوفِ طريقاً أو رفيقا…”
* الملاذ الآمن … المرأة :
على مدى مجموعته على أثير الجليد تختفي المرأة في شعر(عبد الستار نورعلي) إلا من إشاراتٍ نادرة وكأنَّه أراد أن يخوض حربه مع الحياة ومواجهة الغربة لوحده متحلّياً بخلق الفرسان في أن يتصدى لهذا الموضوع بكلِّ شجاعة دون أن يقحم الحبيبة فيه، بل جعل الحبيبة ملاذهُ الآمن بعد أن ينتهي من معركته ويلقي بجسده تحت ظلال نخلتها متأملاً أعذاقها حالماً بتمرها، وليبث لها وجده وما عاناه في رحلته السندباديّة في مواسم الهجر والبعد والمنفى ومعاناته الأبديّة وهو يحمل صخرة الغربة والترحال على كتفه كما في قصيدة (ذريني):
” دعيني ألمسُ الأعذاقَ في نخلي، لعلّي أحصدُ التمرا، فأغرقُ ضفةَ الشطينِ بالأشعارِ والشهدِ كلاماً عامراً بالحبِّ والوردِ دعيني، فالمرايا تعكسُ الأصداءَ في وجهي تجاعيداً طواها الدهرُ في الجلدِ أقامَ مواسماً للهجرِ والبعدِ دمي شريانُ أغنيةٍ..”
ويعكس عدم اقحام الشاعر المرأة في رحلاته وأهواله التمسك بمنظومة القيم الشرقيّة والمرجعيات الثقافيّة والاجتماعيّة التي تسعى لصيانة المرأة وإبعادها عن المصاعب حيث يتكفل فارسها بالدفاع عنها وتحقيق ما يصبو إليه بشجاعته ومثابرته ليعود إلى دفئها وهي تضمّد له جراحاته وتُنسيه أهوال غربته.
وإذا اعتمدنا تأريخ كتابة القصائد كمرجعية لفهمنا لقصائد المجموعة سنجدها تشير إلى حقبة صعبة في حياة الشاعر، وهي حقبة تسعينيات القرن الماضي وما شهدته من تطورات سياسية ضاغطة على الإنسان العراقي بعد أن خرج من حرب شرسة مع ايران ليُزج مع بداية التسعينيات في حرب أخرى، أعقبها حصار دولي مما دفع الكثيرين إلى الهجرة وركوب أهوال الغربة والضياع والتشتت في المنافي إذْ نجم عنها شكل من أشكال الأدب الجديد الذي يعكس إحساس الإنسان العراقي بالغربة، وبالمقابل برز هذا الإحساس حتى لدى من بقيَ في الوطن بعدما حالت الظروف عن خروجهم من أتون الحياة ليعيشوا غربتهم في داخل الوطن ولينعكس ذلك في نتاجهم الأدبيّ.
ولو تناولنا النتاج الشعريّ والسرديّ خلال فترة التسعينيات للمبدعين العراقيين الذين لم يهاجروا لوجدنا الكثير من النتاجات التي تتشح بالغربة والمعاناة، غربة الوطن ،وغربة الروح لما حلَّ بهم، والذي يوازي الإحساس بالغربة الناجم عن ترك العراق.
* عتبات جانبية:
– لقد غلبت التفعيلة على قصائد المجموعة بشكل واضح جداً وكثيراً ما كان الشاعرُ يفخّم موسيقاها بالقافية مُعلياً صوت الإيقاع المتفجر في القصيدة ليوازي إيقاع روحه المتفجرة ألماً وثورة على واقعٍ مرير، فيما لم نلمس ذلك في منجزه المتأخر الذي مال إلى التروي والتكثيف والابتعاد عن الإيقاعات العالية والتي تندرج ضمن توصيف قصيدة النثر وقصيدة (نصّ خارج النصوص) خير دليل على ذلك، وحسناً فعل الشاعر في ذلك لمواكبة تطور القصيدة العربية الحديثة التي اشتغل روادها، السياب، نازك، ومن ثم أدونيس، على النهوض بها لتواكب حركة الشعر العالميّة.
أما لغة القصائد فقد كانت سلسة ومنسابة تبتعد عن كل ماهو غريب وناتيء في اللغة، سعت بجِرسها إلى أنْ تمنح المتلقي حرارة ودفق إحساس الشاعر.
ويتظافر الجِرس الموسيقي مع جمال الصورة الشعريّة لتقدم للمتلقي مشهداً شعرياً اشتغل عليه شاعرنا بمهارة الشاعر الستينيّ، إضافة إلى وجود مقاطع شعرية عالية التكثيف كما في قصيدته (معزوفات غير موسيقيّة للفرح).إن الشاعر عبد الستار نورعليّ من خلال مجموعته الأولى هذه استطاع أن يكون شاهد عصر، ومسلّة رفض لما لحق بشعبٍ بأكمله بعد أن وظف وعيه وقدراته الإبداعيّة ومنظوره الفلسفيّ في إطلاق نشيده:”على أثير الجليد” وليذيب جليد حزنه منطلقاً إلى آفاقه الإبداعيّة الرحبة .

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَ شَاخَ البدْرُ*)
للشاعر:إبراهيم بن يحيى الجعفري(شادي الساحل)
بقلم:محمد سلطان الأمير
____________________
عرض النص:
أَلَا يَا هِنْدُ أَتَعْبني التمني
وَ أرْهَقَتِ الهُمُومُ رَبِيعَ سِنّي
رَأَيْتُ البَدرَ فِي عَيْنيكِ طِفْلًا
وَ شَاخَ البدْرُ مُنْذُ رَحَلْتِ عنّي
رَسَمْتُكِ لِلوِدَادِ بِرِمْشِ عيْني
بِأَجْمَلِ رِيشَةٍ..و بَدِيعِ فَنِّ
كَتَبْتُكِ بِالحُرُوفِ عُيُونَ شِعْرِي
وَ خِلتُكِ تَكْتُبِينَ..وَ خَابَ ظَنِّي !
تَأنّى الليْلُ بَعدكِ..بَلْ تَمَادَى
وَ لَيلكِ قَطُّ مَا عَرَفَ التّأنّي
أَمَا وَاَللَّهِ كانَ الشَّوْقُ أَعْمَى
وَ قَدْ أَسْكَنْتِهِ يَا هِنْدُ..عَيْنِي
رَأيْتُ الشّمْسَ تُشْرِقُ يَا صَبَاحِي
وَ تَضْحَكُ..والصّبَاحُ يَغَارُ مِنّي
تَعَرّى الثّلجُ إِذْ ضحِكَتْ أَمَامِي
و غطَّى الجَمْرُ ذَاكَ الثَّلج عَنِّي
تَرَاقَصَتِ الحُروفُ عَلى شِفَاهٍ
كإصْبع عَازِفٍ يَشْدو بِلحْنِ
وَ بَيْنَ دَفَاتِرِي صَمَتَتْ حُرُوفٌ
فَكَيْفَ لِصَامِتٍ يَوْمًا يُغَنّي !
فَلَا يَوْمِي يَجُودُ بَطَيْفِ أَمْسِي
كَأنّكَ يَا زَمَانُ أَرَدْتَ سَجْنِي
دَقَائِقُ آثَرَتْ ظُلْمَ الثّوَانِي
وَ أَيّامٌ عَلَى السّاعَاتِ تَجْنِي
لِمَهْ يَا عُمْرُ..مَا لَكَ كَيْفَ تَرْجُو-
-مُوَاسَاتِي..وَ أَنْتَ كَتَبْتَ حُزْنِي
أنَا المَكْلُومُ مِنْ غَدْرِ الليَالِي
لِذَاكَ الأمْسِ يَا عُمَرِي..أعِدْنِي
سَحَابَاتٌ تَرَكْتُ هُنَاكَ تَبْكِي
فَأَغْرَقَ حَاضِرِي دَمْعُ التّمَنّي
أ يَسْقِي الغَيْمُ بَحْرًا ضَمَّ مِلْحًا
وَ أسْمَعُ عذْبهُ يَرْجُوهُ..دَعْني!
شَهِيدٌ..هَكَذَا الأيّامُ قالتْ
فَقُلْتُ لَهَا شهيدكِ ! لَمْ تُجِبْنِي.
____________________
مدخل:
لاريب أن طابع النصّ العام هو النزوع إلى الوجدان الواله المترع بالأخيلة الوثَّابة؛والأسئلة الشجيِّة المصطرعة في أعماق الشاعر.
إذ ترفُّ على قسماته وملامحه بدءاً وانتهاءً ظلال الرومانسية الرقيقة؛وسماتها البرَّاقة؛وألوانها المميزة.
أطلق عليه شاعرنا عنوان (وشاخ البدر)؛وهو تركيب مباغت أراد الشاعر-متعمِّداً- قطعه عن سياقٍ سابق عليه
في استئناف الجملة الفعلية بحرف الواو؛ تاركاً للمتلقي استنباطه .
وفيه يخلع الشاعر وسم الشيخوخة المقترنة بالإنسان والكائنات الحيَّة عموماً على صفحة البدرالمنير الذي يحتلُّ مكانةً عالية في نفسه ؛وسيعزف على أوتاره ثانية في البيت الثالث من القصيدة.
ومن موحياتِ هذا التكرار البارزة؛أنه نقل إلينا صلة الشاعرالوثيقة ببدره الأرضي والسَّماوي؛المتحدّين في العديد من الأوصاف والنعوت الواردة في ثنايا القصيدة.
فهو-أي الشاعر- إذا نظر إلى بدره مزدهياً بأشعَّته في قبب السماء؛قصر ساعده عن لمسه وعناقه؛وإذا نظر إليه على كوكب الأرض مرتسماً في محيَّا معشوقته الأثيرة ؛حوصر عن التنعِّم بهالاته الناعمة؛وأنفاسه الحريرية؛نتيجة إقامة السدود الحصينة؛والحواجز المعنوية المنيعة؛وما أكثرها!!
فلذاك صحَّ هنا أن نستشهد بقول الشاعر القديم:
تراه باكياً في كلِّ وقت
مخافةَ فرقةٍ أو لاشتياق!
في هذا الجو المتوتر المحاط بالقلق النفسي؛والمسيَّج بالحوائط العاتية؛
لم يجد الشاعر بُدَّاً من أن يستهلَّ نصَّه بالنداء ؛قابضاً بيده على أداة (ألا ) ذات الوظيفة الاستفتاحية؛ وذلك لمنح نداءه الجهير مساحة صوتية طويلة ؛ لبلوغ مسامع الفاتنة المستولية على سويداء قلبه؛وهواتف بوحه.
ويكشف النقاب عن فاتنته؛في معرض التنويه باسمها «هند»؛وهو اسم عريق يتطابق تراثياً مع هند معشوقة ابن أبي ربيعة في قوله:«ليت هنداً أنجزتنا ما تعد»؛ومع الأخطل الصغير في قوله: «ياهند قد ألف الخميلة بلبل»؛وغيرهما.
والمتعارف عليه أنَّ أسلوب النداء؛يتطلب في أساسه الإفصاح عما في النفس من مطالب ورغبات وأوامر ونواهٍ؛بطرق مباشرة وصريحة ؛وبطرق فنية بلاغية ؛كمثل هذا الموقف المفصلي في تجربة الشاعر.
ويسترعي انتباهي أنَّ الشاعر -إلى جانب استحسانه أسلوب النداء في انطلاقته هذه -لم يعمد إلى رصد خطرات وجيب قلبه المحترق؛واستكناه دواعي آلامه الحادَّة بشكل مباشر صارخٍ فجّ ؛وإنما استثمر ما أُتيح له من أدوات فنية؛ووسائط تعبيرية في يسرٍ وسهولة؛يحدوه الأمل النَّابض في أن تتسق وتتناسق مع مضامين تجربته الشعورية؛وأن تتساوى مع شحناتها الانفعالية المتوهِّجة.
إنَّ عاطفة الشاعر المتأججة؛وإحساسه الموَّار بلوعة الحنين المستبد؛فرضا عليه وصف الشوق بفقدان البصر؛فهو والأعمى المتحيِّر سواء ؛يخبطان خبط عشواء ؛وإنَّه ليؤدي القسم على ذلك؛مُسنداً تهمة إيوائه وسط أجفانه المُسهَّدة؛ إلى محبوبته (هند)؛وكأنَّها بصنيعها هذا أرادتْ نقل مأساة العمى إليه؛أو على الأقلِّ إلزامه مسؤولية رعاية كائن الشوق؛متناسيةً أو متجاهلةً جناية تلك السكنى على راحته المنشودة كما في قوله:
أَمَا وَاَللَّهِ كانَ الشَّوْقُ أَعْمَى
وَ قَدْ أَسْكَنْتِهِ يَا هِنْدُ..عَيْنِي
____________________
-نظراتٌ في بعض تشكيلات النص:
لعلَّ أول صرخة تواجهنا في النص هي هذا البوح الشفاف:(أتعبني التمني)؛وهو تركيب لغوي يكشف لنا عن ألوانٍ من
الأمنياتٍ مما ازدحم بها فؤاد الشاعر؛إلى جانب الهموم الصاهرةالتي اقتحمت عالمه غير عابئه بعمره الربيعي الغضّ..
واستجابة لتلك الصرخة المدويَّة في الفضاءات؛وسعير نارها الملتهب بين جنبيه؛انطلق بنا الشاعر في رحلته الدرامية الدامية بطبيعة الحال؛شاحناً لبناء نصَّة لَبنات من صيغ (أفعال الماضي) على نحو خاص ؛وكْدُه من وراء ذلك رسم أبعاد التجربة ومعالمها ؛ولحظاتها المتباينة بصدقٍ وجلاء ؛آخذاً في الاعتبار آثار تلك الرحلة العالقة في ذاكرته؛وهي آثارٌ مؤرقة لابثةٌ في مغاني آماله وأفراحه؛ومتصلة بمسرح حياته اتصالاً وثيقاً.
فعلى سبيل التمثيل تلوح لنا في خضمّ القصيدة وأنساقها التعبيرية أفعال ماضية -كما أشرت- إنما ذات نكهات مختلفة :(رأيت؛رسمت ؛كتبت ..الخ)؛ حيث نشتم من أريجها البصري ؛والكتابي ؛والفني(التشكيلي).
ولاريب أن توظيف الشاعر هذا منح التجربة حرارتها وتوهجها وتأثيرها في أحاسيس المتلقي؛وفي وجدانه.
وتجئ صيغ (المضارع) موازية لها في عملية البناء الفنِّي كالأفعال(تشرق؛يضحك؛يشدو؛يغني؛يجود؛تجني؛ترجو؛أغرق؛تبكي؛أسمع)و متآزرةً معها في تشكيل ملامح التجربة ومنحها الدينامية اللازمة للارتقاء بها عالياًفي سماء الفن.
نستطيع إذن أن نقول عنها إنَّها استطاعت أن تجسَّد لنا الخطوط العريضة-إن صح التعبير- لمعاناة الشاعر المؤرقة؛وغصصه المشتعلة؛وأشجانه المصطرعة الصَّاخبة في أعماقه.
ولعلّ الخيوط الأولى لمجريات تلك المعاناة؛تبدأ من تحولات بدر الشاعر؛من الطفولة إلى الشيخوخة؛في عيني معشوقته كملحوظة أولى التقطها الشاعر ذاته ؛وهي تحولات مريبة؛تشي بطبيعة اللامبالاة الفاترة من جانب محبوبته المتمادية في الهجران.
وكأني به يودّ أن يقول إنَّ نشأة أواصر المحبة بيننا ؛هي أشبه ماتكون بالمراحل التي يمر بها القمر في رحلته الكونية إلى أن يصير بدراً في مرحلة اكتماله؛ثم تتضاءل إشعاعاته شيئاً فشيئاً؛ وتخفت معالم حسنه الوضاء؛حتى تتوارى تماماً من عالم الوجود ؛ويصبح وقتئذ في مرحلة بائسة يكتنفها العجز والشحوب واللاجدوى ؛كما دلَّ على ذلك قوله تعالى:(وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ)
وتبعاً لما تمليه لفظة(شاخ)؛المرتبطة بمرحلة عمرية معيَّنة.
____________________
-بعض ظواهر النص الفنية:
اشتمل النص على عدِّة مشاهد؛ذات آفاق رومانسية؛على هذا النحو:
1-رحلة غرام الشاعر؛وتفانيه ؛ورِهاناته الضائعة ؛واصطدامه آخر الأمر بخيبة الظن؛إشاراتٌ كافيةٌ لتفسير الصراع النفسي.
2-حضور الأزمنة في التجربة عبر نافذتي: (الماضي؛الحاضر) من جهة؛وعبر استدعائه ألفاظ (الأمس؛اليوم؛الليالي ؛الأيام)الخ؛من جهة ثانية؛وفي ذلك إبراز وإحاطة بجميع نواحي التجربة الشعورية التي خاض غِمارها.
3-استثمار الشاعر بعض مشاهد الطبيعة(الثلج؛غيم؛سحابات؛ جمر ؛إلى جانب بعض الظواهر الكونية:(الليل؛الشمس؛الصباح؛البدر)؛لمشاركته حرارة الإفصاح عن مشاعره المضطرمة وأزماته المتجددة.
4-عناصر :التجسيد والتشخيص؛وبثِّ الحياة في بعض الكائنات من الجمادات أو المعنويات؛تفصح عنها عدة تراكيب لغوية (أتعبني التمني؛ شاخ البدر؛تَأنّى الليْلُ بَعدكِ..بَلْ تَمَادَى؛الشَّوْقُ أَعْمَى؛تَعَرّى الثّلجُ ؛تَرَاقَصَتِ الحُروفُ)الخ.
5-بلوغ الشاعر قمة انصهاره؛واستشعاره مرارة إخفاقاته الراهنة؛والحنين الملحّ إلى أمسه الناعم البرئ ؛حمله على المواجهة ؛في مقام الاعتراف بالتلويح بضمير المتكلم (أنا)؛ بقوله:
أنا المكلوم من غدر الليالي
لذاك الأمس.. ياعمري أعدني!
٦-في البيت الذي ختم به الشاعرقصيدته؛استفهام غرضه الإنكار إلى جانب توظيف فن الاستعارة :
أ يَسْقِي الغَيْمُ بَحْراً ضَمَّ مِلْحاً
وَ أسْمَعُ عذْبهُ يَرْجُوهُ..دَعْني!
ويمكن لنا أن نستشف من وراء دلالاته؛”إدانة الشاعر للوجه المأساوي للحب”؛حيث تُهدر قيمه
في غير أهله؛كالعلاقات النفعية؛ومادار في فلكها.
____________________
لم يبق لي في ختام هذه الدندنة المواكبة لنص شاعرنا؛إلا التلويح والإشادة بقول أديب المهجر الفذ؛ميخائيل نعيمة:
«إنَّ أول ما أبحث عنه في كل ما يقع تحت نظري باسم الشعر هو (نسمة الحياة)؛فإن عثرت فيه على تلك النسمة، أيقنت أنه الشعر، وإلاّ عرفته جماداً، وأن ذاك لا يخدعني بأوزانه المحكمة، ونبراته المنمقة، وقوافيه المترجرجة»
وفي هذه القصيدة وجدت النسمة المشار إليها؛كما وجدتها في غيرها من نصوص شعراء المخملية؛ لاسيما تلك التي حاولتُ الاقتراب من حدائقها المونقة في حدود المستطاع من الرصد والممكن منه؛راجياً من الله أن يحالفني التوفيق؛وأن يلهمني الصواب.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله.

